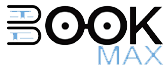صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب آليات الفكر وسؤال السياسة في تجلّيات الحداثة العربيّة، الذي يسعى فيه مؤلفه عبد السلام المسدّي إلى معالجة إشكالٍ كثيرًا ما يتم تناوله في سياق وظيفة المثقف ومدى التزامه قضايا المجتمع أو مدى انحيازه إلى السلطة التي تسيره، وفرضية بقاء المثقف على الحياد باجتناب الإصداح بموقفه حول علاقة الحاكم بالمحكوم، مؤكدًا أن ذاك الحياد ينفي صفة المثقف عن أي باحث أكاديمي، أو عالم متخصص، أو أديب مبدِع.
يتألف الكتاب (532 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثمانية عشر فصلًا. في الفصل الأول، “المثقف والسلطة”، يقول المسدي إن هناك المثقف الذي تنتفع به السلطة ويظل المجتمع معترِفًا له بأنه مثقف، وهناك المثقف المحسوب على السلطة والذي ينقسم المجتمع في أمره؛ بعض الناس يصغون إليه وبعضهم يديرون عنه الرأس. هناك مثقف الجمهور والذي لا رغبة له في معاداة السلطة، وهناك مثقف الجمهور الذي يشتري رضا الجماهير بمعاداة السلطة، وهناك المثقف الذي يغازل السلطة من وراء ظهور الجماهير، وهناك المثقف الذي يتطوع بالانتقال من مترجِم عن خلجات المحكومين إلى مترجِم لمقاصد الحاكمين، لأنه يستطيب أن يتحول من مبدع للمتن إلى حاشية على هامش النص، وغير ذلك.
ذاكرة ووعي
وفي الفصل الثاني، “الذاكرة الكليمة”، يتناول المسدي الكتابة التي زمنها غير زمن ما تتضمنه، ومسألة نشأة الظالم، والجدل النظري الذي أفضى إلى تأسيس نظرية المستبد العادل. يسأل: هل الشعوب هي التي تصنع طغاتها أم هم الطغاة يروّضون شعوبهم على الطاعة والانصياع؟ مَن يصنع مَن؟ الظالم أم المظلوم؟ المتجبّر أم المقموع؟ الحاكم أم المحكوم؟ برأيه، الجبروت السياسي ظاهرة معقدة جدًا وتشتمل على ظواهر متوالجة يصفها الواصفون ويحلِّلها المحلِّلون، وتشخيصها عادة ما يتم من خارجها. “وهنا تأتي أهمية الشهادة الفردية حين تنخرط في ميثاق السيرة الذاتية، وهنا تُطرح قضية أخرى لن تقل أهميتها عن أهمية المسألة الجوهرية الأولى؛ إنها قضية الوعي بتوَلد الحكم المطلق، أعني: متى ينجلي الوعي بالظاهرة؟ وكيف يتشكل إدراك الناس لها؟ ماذا يحصل لدى المثقف النقدي من مترتبات ملازمة لذاك الوعي؟ وفي المقابل: لماذا يغيب الوعي؟ وكيف تتروض النفوس على مداراة الظلم والطغيان؟ ولكن السؤال الأقسى: كيف تتحدد مسؤولية المثقف بعد إدراكه التصادم العنيف بين آلياته الفكرية ومشاهداته السياسية؟”
ويقول المسدي في الفصل الثالث، “بشائر الوعي الجديد”، إن تراكمَ المعلومات مهما تعددت مصادرها، ومهما تنوعت منافذ استيعابها، بل مهما اختزنتها الذاكرة بالحفظ يتلوه استحضارُ البديهة تفصيلًا وتدقيقًا، لا يمثل في حد ذاته قيمة مطلقة في مواثيق المعرفة، إنما القيمة غير المقيدة تكمن في طريقة التعامل مع كل المعلومات المتجمعة بتحويل تراكمها الكمي إلى نسق كيفي. “ولك أن تختزل المعضلة في أوجز العبارات: المعرفة منهج قبل أن تكون تحصيلًا، والمعرفة أن تعرف كيف تسُوس المعلومات، وما العلم إلا سياسة محاصيل المخزون المعرفي، فهو تدبير وبناء لا نقل ولا حكاية ولا ترديد، ولا هو رجعٌ لأصداء الذاكرة”.
في التأويل وإكراهات السياسة
وفي الفصل الرابع، “براءة التأويل”، يرى المؤلف أن مأساة المثقف تبدأ حين يدركه اليقين أن النظام القائم في بلاده يستوي في مظاهره وفي مؤسساته كل شروط الحياة المدنية الآمنة، وأن الحقوق والواجبات مرسومة على دفاتر الدساتير وصحائف القوانين، فيخال حينئذ أن المعادلة متكافئة بين مَن ينتجون الأفكار، وهو منهم، ومَن يصنعون القرار، وهُم أهل التدبير، وشيئًا فشيئًا يستيقظ من غفلته، وإذا بكوابيس الحلم المزعج حقيقة واقعة: الاستبداد ولا شيء سواه، ويرى رأيَ العين الجينات الدموية التي تفرخ في خلايا الحاكم المُستوحِد، تنمو وتتعاظم، ثم تتكاثر تكاثرًا مهولًا حتى تُحوّل الإرادة السلطانية إلى ماردٍ إذا تحرك على الأرض سَوى بها ما عليها.
ثم يقول في الفصل الخامس، “السياسة والفكر النقضي”، إن سلطة الخطأ في الفعل السياسي أعظم كثيرًا ممّا تكون عليه في الإنجاز الفكري وفي الإنتاج المعرفي وفي التدبر الثقافي؛ لأن الخطأ، الذي هو استراتيجي بالضرورة، غلابٌ قاهر، وسلطته متجددة بذاتها، سواء اتصل بفعل القرار أو جالَ في حقل الخطاب، والسبب هو أن فعل الكلام في غير السياسة منفصل عن فعل الحدث، أمّا في السياسة، فالكلمة في حد ذاتها فعلٌ يتنزل بمنزلة الوقائع. برأيه، “تلك مصادرات نضعها كما لو أنها معلومة بالضرورة، وهي فعلًا كذلك عند مَن يستطيع وعيُه السياسي النظري اختزال مسافات التحليل والاستغناءَ عن حواشي الشواهد الابتدائية. هي إذًا مسَلّمات يمكن أن نقرأ الراهن في ضوئها، بل هي تساعد على الكشف عن البذرة النواة في جوهر الخطأ السياسي السائد، وكيف تحددت لحظته النشوئية الأولى، ثم كيف تخلقت خلاياه في رحم الأحداث المتعاقبة، ومنذ البدء نصوغ ما نروم الكشف عنه؛ أن جوهر الخطأ السياسي الأكبر يكمن في التحريف النظري والإجرائي الذي نراه يطرأ على مفهوم البراغماتية كمبدأ مرجعي وكآلية إجرائية”.
وفي الفصل السادس، “إكراهات السياسة”، يجد المسدي أن في العالم النامي، كانت الثقافة دومًا هي كبشَ الفداء عند حصول أدنى ضائقة اقتصادية، “وشيئًا فشيئًا تحولت الثقافة إلى كبش الفداء عند أولى مفارقات السياسة الدولية”. وهكذا ما انفك الشأن الثقافي يحمل أعباء السياسة ثم يقع تطويعه كي يكون رأس القاطرة في الحملة النسقية التي تسعى إلى صَهر الهويات الإنسانية في هوية استباقية جديدة ستكون هي بالفعل اللاهوية. ومقولة التنوع الثقافي تعيد إلى أذهاننا مقولة أخرى عرفت نشأتها في الولايات المتحدة واعتنقتها فرنسا بعد أربعين عامًا؛ إنها مقولة المَيْز الإيجابي.
حرية ومسؤولية
يرى المؤلف في الفصل السابع، “في الحرية والمسؤولية”، أن الفكر الحر يزدهر في دائرة الحوار بين الشأن الثقافي والشأن السياسي، والحرية في هذا التقاطع الدقيق متحددة بغياب التسخير الحزبي، وشأن الفكر النقدي ألا يأتمر بأوامر الحزبية، وألا يكون خادمًا للمذهبية الأيديولوجية، بل أن يكون مَرجعُه العقل الخالص الذي ميثاقه مطابق لمواثيق العلم وقواعد المعرفة ومحاضن الموضوعية؛ “ومن هذا الباب يَنفذ معيار قبول الرأي المخالف؛ فالفكر الحر ضابطه الأقوى هو رجحان الأدلة وتدافع البراهين، والذي فيه يتبارز معيار الفكر ومعيار السياسة هو أن الفكر المقيَّد يرفض الرأي المخالف، وإذا قبله فإنما يقبله على مضض، إذ يرى في قبوله انخذالًا، بينما ينطلق الفكر الحر من فلسفة مغايرة مفادها أن في قبول الرأي المخالف قوة وشجاعة تفوقان قوة التعبير عنه وشجاعة صياغته، أمّا بين القبول والرفض، فلا وجه للمقارنة في سنن العقل، لأن في الرفض إقصاءً للذات على نفسها وإلغاءً لمبرر الوجود.
وفي الفصل الثامن، “العقل الثقافي”، يقول المسدي إن مفهوم المسؤولية يستمد أصوله التكوينية من المنبع الروحاني الذي قيدته الأديان بثنائية الثواب والعقاب المنصهرَيْن في مفهوم الجزاء، “فكان مضمونه مرتبطًا بفكرة السعي بعد تحديد الغرض المبتغى، ومن ذلك اقترن المصطلح في جوهر معناه بمبدأ الغائية. ثم استقامَ مفهوم المسؤولية أسًّا من أسس الفلسفة الأخلاقية، وحامَ مدلوله حول علاقة الفرد بالمجموعة البشرية التي تحتضن وجوده انطلاقًا من رسم مقومات التعامل داخل المجتمع بين الجزء والكل، وهو ما يسطر ضوابط السلوك الفردي والجماعي، وقد آلت دلالة المسؤولية في فلسفة الأخلاق إلى الاقتران بفكرة المنفعة وجبر الضرر فاندرجت اندراجًا صريحًا ضمن ثنائية الحق والواجب. واستنادًا إلى كل ذلك، انبثقت ضمن الفلسفات المدرسةُ التي جعلت معنى الوجود البشري رهين مبدأ المسؤولية بحيث لا يتسنى للفرد تحقيق علّة كيانه ضمن الجماعة إلا إذا تقمّصَ أفعاله بذاته، فأقرّ بأنه ’مسؤول عنها‘”.
ويحاجّ المسدي في الفصل التاسع، “الميثاق المدني”، بأن من أمانة المثقف في أمتنا العربية: أن يتابع الحدث السياسي ثم يضعه تحت عدسات الفكر النقدي، ناشدًا أن يُؤديَ أمانته من حيث هو مثقف: ملتزمٌ، عضوي، نقدي. ألا إن في الزمن عِبَرًا. وقد انتهى التطور البشري في مساره التحديثي الراهن إلى الاندراج – طوْعًا أو كَرْهًا – ضمن مجتمع إنساني مُعَوْلم تتسارع فيه الخطى القافزة على حركة التاريخ، “فنرى كيف تضاعف نسَق تلك الحركة في جَرْي لاهث يوشك أن يُفقِدَ الإنسان الوعي الحسي باليومي وبالمَعيش، مُذعنًا إلى سلطان الرقمنة؟ وهكذا بات الجوال في قبضة اليد – وما هو إلا كتلة من الأخلاط المعدنية تزن بضعَ عشراتٍ من الغرامات – سلاحًا جبارًا يَكسر حواجز المكان، ويَدُكّ حواجز الزمان، فيَفتح خزائنَ المعلومات الكونية المطلقة، وإذا بالإنسان غير الإنسان، وإذا بمَلكات العقل تقفز من منزلة الإدراك المقيد إلى منزلة الإدراك المنسرح”. يضيف “اجتمع على حياة الناس فائض السعادة وفوائض الشقاء المقترن بالإنهاك وانكشاف المستور ثم بتهاوي الأقنعة، وكان أن اقترنت المتناقضات: التمدن المتسامي والتوحش المفترس، إنه الانتظام الكوني الأجَد، حيث تتمرد مقولة ’إن البقاءَ للأقوى‘ على مقولة ’إن البقاء للأصلح‘”.
تفسير وتأويل
في الفصل العاشر، “التفسير والتأويل”، يتناول المؤلف الفكر العربي، فيقول إنها عبارةٌ عنيدة، ما تقوله طاقتُها الإيحائية أهم ممّا تفيض به طاقتُها التصريحية، والحدسُ الدلالي يؤكد بالاستشعار أن النعت الوارد فيها – وهو العربي – لا يَنبع من منظومة الأعراق ولا من سياق الشعوب بالدلالة التي وردت بها اللفظة في النص القرآني، وإنما هي مستنبَطة من دلالة لفظ “العربي” على “اللسان”؛ “نعني أنها منسوبة إلى اللغة العربية وهو ما يعني – في أول المطاف وفي نهايته – أن عبارة ’الفكر العربي‘ تحدد المُنتجَ الفكري الذي صيغ باللغة العربية، سواء أكان صائغوه عربًا أقحاحًا أم كانوا من الشعوب الأخرى التي انصهرت ضمن دائرة الانتماء الحضاري الجديد، فكان ميثاق انتمائها هو الانخراط اللغوي، وما من ارتياب أن ذاك المحرك الخفي يظل نشيطًا متحفزًا ليدفع ثنائية الأنا والآخر كي تغادر جُحْرها، حيث تحتل فضاءَ اللاوعي متوارية متربصة”.
وفي الفصل الحادي عشر، “الجواهر والأعراض”، يتناول المؤلف الحداثة، فيقول إن “في الفكر الغربي تنصهر المادة والموضوع وتنصاع اللغة خادمة لهما، وهو ما به يستوي المنهج أقنومًا قائم الذات، مُوَلّدًا مِخصابًا إلى حدود الطفرة أحيانًا. أمّا في المنظور العربي، فالحداثة موقف، وقد يَحْصل لها أن تخلخِل مرجعيات الفكر، فتخترق الموثوقات، فيَغدو اللحن معها صوابًا، والكسرُ جَبرًا، واللانظام نسقًا. الحداثة عندنا ليست موقفًا من المعرفة ولا موقفًا من التاريخ فحسب، وإنما هي أيضًا مُحَددٌ مَكين وسط معادلة الأنا والآخر؛ هذه المعادلة التي لم يَعُدْ لها وجود في الغرب إلا ضمن منطق الصراع على السيادة، أو ضمن منطق الثأر من التاريخ. إن مقولة التراث عندنا هي اليوم – رغم كل التناقضات الظاهرة – أغزرُ طرافة وأكثر إخصابًا، إذ تتنزل متفاعلة مع اقتضاءٍ آخرَ يقوم مقام البديل الفكري؛ هذا البديل مدارُه التراث من حيث يدعونا بإلحاح إلى ارتياده، ويتطلب ذلك أننا نواجه تراثنا لا على أنه مِلك حاضرٌ بين أيدينا وإنما على أنّه مِلك افتراضي يظل موجودًا بالقوة ما لم نستردّه، واسترداده استعادة له، واستعادته حَمْله على المنظور المنهجي المتجدد”.
أما في الفصل الثاني عشر، “السياسة وفتنة اللغة”، فيقول المؤلف ليست نكبة اللغة في تجريم الإنسان لها، وإنما هي في غفلة الإنسان عن أخيه الإنسان الذي يتآمرُ عليها وعلى إخوته، فيُخرجها من فِطَر البراءة إلى محتشدات الكيد بالدلالات المضمرة؛ وعندما تدْلَهم السجوف، وتتلبد السماء غيومًا، كثيرًا ما يَهرع العقل الناقد إلى المراكن فيحتمي بالأسطوري، أو يستظل بظل الخرافي، أو يستنجد بالمأثور الميتولوجي؛ إذ ليس للكلام من دلالة في ذاته، والحصيف مَن لم يستنبط منه رسالته إلا بعد أن يجيب عمّا يلي: مَن القائل؟ وأين قال الذي قاله؟ ومتى قاله؟ فإذا ما بادرَ الطفل إلى الإجابة وكان مُلمًّا، بليغًا، مدقّقًا، باغته السائل بسؤال رابع: عمّ كان يتحدث المتحدث؟. ويضيف: “إن الذي تمرس بلعبة الخطاب فأتقنها وزادَ عليها بفائض يجمع إلى بلاغة العرب وخطابة الإغريق شيئًا من فصاحة الرواقيين، حين أصبحت الفلسفة في مضيق الخطاب هو الذي يهتدي بنفسه إلى خلاصة الخلاصات، فيدرك أن نتائج الكلام كثيرًا ما تكون أكثر صحة من مقدماته”.
السيرة واللغة
ويسوق المسدي في الفصل الثالث عشر، “في مسؤولية الثقافة”، أسئلة كثيرة. يقول: “على مدارج اليقظة الثقافية الجديدة لا بد لك أن تتساءل: كيف تواجه المعرفة – من حيث هي علم خالص- الواقعَ الإنساني الجديد في تشكّله الأممي على الواجهة السياسية، وفي تكيّفه العالمي على الخريطة الاقتصادية، وفي تلبّسه الكوني على الشاشة الفكرية؟ ومَن المؤهل بين المختصين بحقول العلوم الإنسانية كي يحلل لنا صراع المعايير الثقافية بين الكونية والخصوصية تحليلًا نقديًا عالمًا يتجاوز التعبير عن الموقف المبدئي العام، ويتجاوز الصياغة النضالية التي قد تلهب الأحاسيس ولكنها لا توقظ العقل؟ هل هو الفيلسوف أم المؤرخ أم عالِم الاجتماع؟ وهل هو الناقد الأدبي ساعة ينتقل إلى حدائق النقد الثقافي، أم ذاك الذي احترف تاريخ الأفكار وصناعة الآراء؟ ثم ما عسى أن تكون درجة الإصغاء وذبذبة التصديق عندما يقفز إلى الواجهة الأمامية كل الذين احترفوا النضال المذهبي في يوم من الأيام، يحفزهم الأملُ أن تسود أفكارهم التي تضرب في أعماق الوعي الفلسفي؟ ولك أخيرًا أن تتساءل: ما مدى تأثير المعرفة في الوعي الثقافي العام؟ وما مدى تأثير الثقافة في الوعي المعرفي الخاص؟”.
وفي الفصل الرابع عشر، “كتابة السيرة ومأزق اللغة”، يقول المؤلف إن كتابة السيرة الذاتية “إمّا أن تجْنحَ بصاحبها إلى استكشاف نفسه من خلال البيئة الاجتماعية التي تلازمه في شتى مراحل حياته، وإمّا أن تأخذه إلى مساءلة العالَم المحيط به من خلال إحساسه بكينونته الوجودية. وقد يتداخل النهجان، ولكن الكتابة تظل تشي في كل مشهد من مشاهد الخطاب برجحانِ أحد المنزعَيْن على الآخر. ولنا دائمًا في كتاب الأيام لطه حسين شاهد بليغ على السيرة الذاتية حين تمسي تدوينًا لتاريخ المؤسسة من خلال عبور الكائن الفرد بين دروبها”.
وفي الفصل الخامس عشر، “اللغة العربية واللسانيات”، يقول المسدي إن الذاكرة تطل علينا وكأنها قيّمة على تدوين رحلة العلم بما يُصاهِرُ التاريخ بالجغرافيا في غير ما تفاضل إبستيمي، وما من تحديث احتضنته الثقافة العربية إلا عَرَف في بداياته أوجاعًا كأوجاع المخاض التي تسبق الوضع؛ “أمّا المَأثم في كل ذلك، فمَرْجعُه إلى أن وهْمًا ثقافيًا ما فتئ يستبد بالنفوس كأنه اليقين الذي يخايلُ ناظرَه حتى أمسى عَصيًا منفلتًا، فأذعن إلى سلطانه ذوو العقول المرتجفة من دون أن يَنجُوَ منه ذوو الألباب العتيدة، وهو أن التحديث ينال من قداسة الموروث نيْلًا فاتكًا، فترتبك له النفسُ المطمئنة؛ وبناءً على ذاك، يميل الظن الشائع إلى إدراج المُحْدث ضمن الخاص الذي هو من المقيم الجزئي لأنه عابرٌ، وقبالته يقف العام الذي هو مقيمٌ كلّي والذي بإغوائه يلاطف حساسية البَشرة العارية؛ على ذاك المنوال كانت رحلة اللسانيات إلى الثقافة العربية على حد ما كانت هجرة فقه اللغة العربي إلى علم اللغة الكوني”.
حداثة العرب
أما في الفصل السادس عشر، “العرب وأفق الحداثة”، فيرى المؤلف أن لا سبيل إلى كتابة تاريخ الحداثة العربية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية إلا بإقامة جسر متحرك بين العلم اللغوي وعلم الخطاب، من حيث هو شامل علمَ الشعر وعلمَ فنون النثر وعلم النص بصفة عامة، والسبب في ذلك أن استنباط اللساني لنواميس الظاهرة اللغوية يظل ناقصًا إن لم يتقصّ أسرارَ الخطاب الإبداعي، وأن استكشاف نقّاد الأدب لشعرية الخطاب يظل مبتورًا ما لم يتسلح بمعرفة الخصائص اللسانية الواسمة للبنى التركيبية التي تَحْكم الخطاب التداولي. فكلا الرافدين يغتني بإمداد رديفه من دون أن ينالَ التنافذ المزدوج من حصانته المعرفية شيئًا، إنما طرائق البحث وأسْيقة الاستثمار تؤتي أنفالها على الواهب وعلى الموهوب له.
ثم في الفصل السابع عشر، “السيرة الذاتية بين الحقائق والتمثّلات”، لا ينفك المؤلف يردّد أن فضل المؤسسة على المثقف العربي أقوَى مَددًا وأوسَعُ إشعاعًا من فضل المثقفين حين يظلون أفرادًا؛ “كل فرد منهم واثق بذاته وُثوقًا تامًّا، لكن المؤسسة الثقافية وزنُها بوزن مَن عليها. بين مجال اللغويات، وحقل النقد الأدبي، وفضاء الأسئلة الحضارية المنبثقة من إشكاليات الثقافة العربية، والتأملات التي تقرن الفكر بالسياسة كما هي الحال في سياق كتابنا هذا؛ وجدت نفسي ’محظوظًا‘ بتواتر الدعوات التي كنت أتلقّاها من مؤسسات أكاديمية أو ثقافية من أقطارنا العربية المتعددة. وكان لي أن أدركت منذ الزمن الأول أن المعرفة كيان ’موجودٌ بالقوة‘ ولا يُخرجه إلى ’الوجود بالفعل‘ إلا مهارة تتضافر فيها مواهبُ عديدة يمكن أن تُسمّيَها، على سبيل المجاز، استراتيجية المعرفة، أعني بها آليات إبلاغها بحسَب الذين تتجه إليهم بالخطاب”.
وفي الفصل الثامن عشر والأخير، “السيرة والمخيال السردي”، يقول المسدي إن كتابة السيرة الذاتية عسيرة وشاقة، “وأعسرُ منها وأشق عكوف الناقد على أدب السيرة، لكن الأمرَّ والأضنى أن يتوسل المثقّف بأدب السيَر لينسج سيرته الفكرية الخاصة من خلال سِيَر الآخرين، مغامرًا بركوب المطايا غير الآمنة، “أفلا أكون يا قارئي قد وُفّقتُ في إقناعك بهذا وقد بالغت في تكراره؟”.