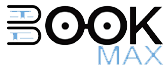صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من سلسلة ترجمان، كتاب أوكرانيا وروسيا: من طلاق متحضر إلى حرب همجية لبول دانييري، وترجمة يزن الحاج، يقع الكتاب في 432 صفحة، ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام.
يستكشف الكتاب الديناميات داخل أوكرانيا، وبين أوكرانيا وروسيا، وبين روسيا والغرب، والتي ظهرت مع انهيار الاتحاد السوفياتي وأدّت في النهاية إلى الحرب في عام 2014. واستنادًا إلى التسلسل الزمني، يوضح أن انفصال أوكرانيا عن روسيا في عام 1991، الذي كان يسمى في ذلك الوقت “الطلاق الحضاري”، قد أدّى إلى ما يسميه كثيرون الآن “الحرب الباردة الجديدة”. فيجادل بأن الصراع قد تفاقم بسبب عوامل أساسية ثلاثة: المعضلة الأمنية، وتأثير التحول الديمقراطي في الجغرافيا السياسية، والأهداف غير المتوافقة لأوروبا ما بعد الحرب الباردة. وبموازاة وضع سلمي جرى تبديده، كانت الخلافات الحاضرة سلفًا والعميقة الجذور تستعصي على الحل، وتسهم في إطالة أمد الأزمة. ويُظهِر الكتاب أيضًا تناسب هذه الحرب مع الأنماط الأوسع للصراع الدولي المعاصر، ومن ثم ينبغي أن يجذب الباحثين في الصراع الروسي – الأوكراني، وعلاقات روسيا مع الغرب، والجغرافيا السياسية عمومًا.
منابع النزاع على أوكرانيا
يشدّد هذا التوصيف على أنّ الحرب التي بدأت في عام 2014 كانت نتاج قوى المدى البعيد في بيئة ما بعد الحرب الباردة، وقرارات المدى القصير التي اتّخذها الزعماء الأوكرانيون والروس والغربيون في عامَي 2013 و2014، على حدّ سواء. فقد ارتفعت احتمالات اندلاع نزاع عنيف بين روسيا وأوكرانيا ارتفاعًا تدرجيًا بين عامي 1989 و2014، ومن الضروري اقتفاء هذه السيرورة لفهم كيف بات ممكنًا، في عام 2014، أن تقرر روسيا أنّ غزو جيرانها كان سياستها الفضلى.
كانت البيئة التي نشأت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي أقلّ حدة بكثير من بيئة الحرب الباردة؛ فقد بات سهلًا الاعتقاد بأنّ النزاعات التي تبقّت، مثل وضع أوكرانيا، ستحلّ نفسها مع مرور الزمن. غير أنّ عوامل رئيسة ثلاثة – عدم قابلية تسوية تصوّرات الأطراف الفاعلة العديدة إزاء الوضع القائم والحاجات الأمنية الناتجة، وتعارض انتشار المؤسسات الديمقراطية الغربية مع تصوّرات روسيا عن “مجال مصالحها”، والأثمان الداخلية لتبنّي سياسات تصالحية – تضافرت لتؤكّد أنّ وضع أوكرانيا لم يُحلّ. وللمفارقة، كانت أرجحية أن يُحَلّ الوضع حلًا حاسمًا في صالح الغرب أو لفائدة روسيا هي ما جعل كلا الطرفين أكثر تقبّلًا للمجازفات في عامَي 2013 و2014.
ما كان لزامًا أن تقع الحرب، ولكن بحلول عام 2014 كان التنافس والشكّ قد ترسّخا بقوّة في العلاقات الأوكرانية – الروسية والغربية – الروسية على حدٍّ سواء، وأمسى هذان النزاعان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا. وكانا متأصّلَين في منظومة ما بعد الحرب الباردة، ولفهم السبب لا بدّ لنا من العودة إلى الأحداث الصاعقة التي أنهت الحرب الباردة في الفترة 1991-1989.
من الثورة إلى الحرب
داخل أوكرانيا وعلى الصعيد الدولي، وصلت الأمور التي تفاقمت طوال سنوات إلى ذروتها. واحتمال فوز أحد الجانبين في المعركة فوزًا دائمًا دفع من كانوا في الجانب الآخر من النزاع إلى رفع مجازفاتهم. فداخل أوكرانيا، كانت المساعي التي بذلها فيكتور يانوكوفيتش لتعزيز سلطته، لتصبح سلطة مطلقة، قد دفعت المحتجين إلى محاولة حمله على تغيير مساره، ثم محاولة إقصائه من السلطة. بين أوكرانيا وروسيا والغرب، بدت احتمالية أن إطاحة يانوكوفيتش ستؤدي إلى إعادة توجيه أوكرانيا بصفة دائمة نحو الغرب كان سببًا في إقناع بوتين بأنه لم يعد لديه الكثير ليخسره، بل ربما ثمة الكثير ليكسبه، في الاستيلاء على الأراضي التي طالما طالبت روسيا بملكيتها.
وكانت فترة “يورو ميدان” أو “ثورة الكرامة”، من أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 حتى 22 شباط/ فبراير 2014، للقرارات الصغيرة فيها آثار كبيرة وغير متوقعة في كثير من الأحيان. وأدى قرار أوّلي بضرب المتظاهرين في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى تصعيد كبير في حركة الاحتجاج. وأدى إقرار “قوانين الدكتاتورية” في منتصف كانون الثاني/ يناير إلى إحياء حركة احتجاج آخذة في الانحسار. وأدت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يومَي 18 و20 شباط/ فبراير إلى انقسام الموالين ليانوكوفيتش. وكان من المتوقع لقرار المحتجين برفض اتفاق، جرى التفاوض عليه بين دبلوماسيين أوروبيين وروس، أن يدفع يانوكوفيتش إلى قمع شديد، ولكن بدلًا من ذلك، انهار النظام في غضون ساعات.
وفي حين كان من المستحيل التنبؤ بمسار الاحتجاجات، بدا تأثير النتائج واضحًا: كانت أوكرانيا على وشك التحول نحو أوروبا. وردَّ بوتين بغزو شبه جزيرة القرم وضمّها وبإثارة تمرد في شرق أوكرانيا. ويبدو أن البديل بالنسبة إلى بوتين كان قبول خسارة أوكرانيا. ومن الواضح أنه كان خيارًا متاحًا؛ إذ إن روسيا تعهدت بالتزامات في معاهدات في هذا الصدد. ولكن بوتين اختار اغتنام الفرصة الفريدة التي قدّمت نفسها للاستيلاء على شبه جزيرة القرم والمراهنة للحصول على جزء أكبر بكثير من أوكرانيا. ولا نعرف إذا ما كان يأمل، من خلال دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، تكرار سيناريو شبه جزيرة القرم، أو كان ينوي خلق حالة عدم الاستقرار المستمرة التي نتجت من ذلك.
النزاع الجديد في أوروبا
أين يترك هذا أوكرانيا؟ خوض حرب لا يمكنها الفوز بها ولا يمكنها إنهاؤها. أوكرانيا عاجزة عن استعادة شبه جزيرة القرم أو دونباس المحتلة، وعاجزة أيضًا عن التخلي عنهما. الاحتمال هو أنها ستتعامل مع هذا النزاع سنوات طويلة؛ فقد عزّز الهجوم الروسي وضع أوكرانيا بوصفها محورًا للنزاع بين روسيا والغرب، وبذا ارتفعت فرصة التعاون مع الغرب ارتفاعًا دراماتيكيًا من جديد بعد عام 2015 .
كان دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز النفاذ في عام 2017 تجسيدًا لتلك الفرصة. وكما هي الحال دائمًا، كان السؤال المطروح إذا ما كان في وسع أوكرانيا أن تغتنم هذه الفرصة، وكما هي الحال دائمًا، يبدو أن الإجابة هي لا. ويبدو أن روسيا تراهن على أن أوكرانيا غير قادرة على الإصلاح، بخاصة في ظل التدخل الروسي، وأن الغرب سيفقد اهتمامه بالوضع قبل أن تفعل روسيا ذلك. قد يكون هذا صحيحًا. ولا يزال عجز أوكرانيا عن الإصلاح، وليس السياسة الروسية، ما يشكّل التهديد الأكبر لأمنها القومي.
أين يترك هذا روسيا؟ فمن ناحية، قد يُنظر إلى روسيا على أنها المنتصرة؛ إذ أثبتت أن رغباتها، وليس فقط القواعد الغربية، ستشكّل ما يحدث في أوروبا الشرقية. ولكن من نواحٍ أخرى، روسيا اليوم في الموقع الذي لا تتمنى أن تكون فيه: معزولة سياسيًا عن بقية أوروبا، ومرفوضة رفضًا حاسمًا من أوكرانيا. وكما كانت الحال في أحيان كثيرة، فإن جهود روسيا لتعزيز أمنها جعلتها أقل أمنًا. اكتسبت روسيا مجالَ تأثيرٍ غربيًا، وإنْ كان صغيرًا لا يشمل إلا بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم وجزءًا من دونباس. فضلًا عن ذلك، فإن الحفاظ على هذا المجال مكلف. قد تكون روسيا قادرة على إبقاء أوكرانيا خارج المؤسسات الأوروبية، ولكن هذا أقصى ما يمكنها القيام به الآن.
هذه المعركة عالمية وأوروبية على حد سواء. فعلى الصعيد العالمي، السؤال المطروح هو: أكان العالم سيكون أحادي القطب أم متعدد الأقطاب؟ لدى روسيا حلفاء عديدون، أهمهم الصين. ولكن مع استمرار تآكل هيمنة الولايات المتحدة الأميركية، فإن من المرجح أن تستمر جاذبية النموذج الغربي على الرغم من محنته الحالية. التأثير الصيني كبير، غير أنه يكاد يكون عمليًا بالمطلق تقريبًا؛ أي معتمدًا على الحوافز المادية الملموسة بدلًا من أيّ قيم مشتركة. أظهرت روسيا قدرتها على الأذى وتكوين صداقات بين الأنظمة المنبوذة، ولكن سيبقى رهنًا بالمستقبل رؤيةُ إذا ما كان ممكنًا أن تكون هذه الأنظمة مساهمة فاعلة في نوع القوة العظمى الذي تتوق إليه.
وعلى المستوى الأوروبي، فإن السؤال المطروح هو: أين سيُرسَم الخط الفاصل بين منطقة الاستبداد التي تهيمن عليها روسيا، ومنطقة الديمقراطيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي؟ هنا، لدى روسيا عدد قليل من الحلفاء. سيكون الحفاظ على مجال تأثيرها الصغير مكلفًا، وسيكون توسيعه أكثر تكلفة. ومع أن روسيا حققت بعض النجاح في زرع الانقسامات داخل الديمقراطيات الأوروبية، فإن هذه الممارسة تُبعدها من الاحترام المؤسساتي الذي تطالب به.
هل ثمة رؤية للنظام الأوروبي تتسق مع المعايير الغربية وتطلعات روسيا إلى أن تكون قوة عظمى؟ هذا هو السؤال الأساسي المتصل بالأمن الأوروبي الذي لم يُحَلّ منذ عام 1989. وكما حدث في ذلك العام، يبدو أن الإجابة بعد عام 2014 هي “لا”، فالأمن في أوروبا الغربية مبني على ضبط النفس القائم على القوة العظمى بطريقة فشل الكثيرون في تقديرها.
وفي ظل عدم وجود اتفاق بشأن بنية النظام الأوروبي، لا يبقى إلا التنافس. وفيه، تظل الديمقراطية محورية بالنسبة إلى قيم الغرب واستراتيجيته. الآن، كما كانت الحال في الحرب الباردة، تتلخص استراتيجية الغرب في انتظار وصول نظام أكثر ودًا إلى السلطة في روسيا، وعلى الأخص انتظار مطالبة الشعب الروسي بحكومة ديمقراطية. ومع ذلك، وكما أظهر ربع القرن الماضي، إذا كان تبنّي الديمقراطية يعني التخلي عن هوية القوة العظمى في روسيا، فإن كثيرًا من الروس سيعارضونها.
إذا كانت استراتيجية الغرب قائمة على انتظار وصول الديمقراطية إلى موسكو، فإن استراتيجية روسيا تستند إلى مساعدة الأوتوقراطيات والأفكار المناهضة للاتحاد الأوروبي/ الناتو على الوصول إلى السلطة في العواصم الغربية. ومنذ عام 2015، يبدو أن روسيا تكسب معارك في الغرب أكثر مما يكسبه الغرب في موسكو. وإذا كان لروسيا أن تحقق شكل أوروبا الذي تسعى له، فلا بد لهذه السياسة الجديدة أن تنجح؛ لأن الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس لم يحقق هذا الهدف.